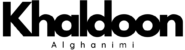أثناء نشأتنا في الشرق الأوسط، كان الكثير منا محاطاً بمشهد لغوي شكلته المحظورات والتحذيرات العميقة، وكلها متجذرة بعمق في صراع وجودي مع الغرب. إن عبارات مثل “الغرب يتآمر ضدنا دائمًا”، و”إنهم لا يريدون سوى سقوطنا”، و”نحن محاصرون بالمؤامرات الغربية” لم تكن مجرد خطابات بلاغية ولكنها شكلت حجر الأساس لعقلية جماعية ترى في الغرب خصمًا منتشرًا في كل مكان. ولم يقتصر هذا المنظور على مجال واحد من مجالات الفكر أو الحكم؛ بل قد تجاوزت الحدود السياسية والدينية، ووجدت أرضية مشتركة بين الأيديولوجيات المتنوعة.
فالأنظمة الدينية الثيوقراطية، والديكتاتوريات القومية، والحركات اليسارية، يرددون لازمة مماثلة: “لقد سعى ويسعى الغرب، بأجنداته الخبيثة، إلى إيقاعنا في شرك، وتقويض قيمنا وسيادتنا.” وقد أدى هذا الإجماع إلى ولادة معجم سياسي فريد من نوعه في الشرق الأوسط، وهو عبارة عن مجموعة من المصطلحات والتعريفات التي رسمت حدود الخطاب المقبول. وبدا الأمر كما لو أنه قد تم وضع آداب سياسية تحدد الولاء والمعارضة من حيث الالتزام بهذا الرمز اللغوي. إذا انحرفت عن هذا الدليل غير المكتوب، فستجد نفسك سريعًا موصومًا بالمتعاون مع الغرب، وهو اتهام يمكن أن يشوه سمعتك ومسيرتك المهنية بين عشية وضحاها في الشرق الأوسط.
وأصبح مصطلح “الأجندة” مشحونا بشكل خاص، ومشبعا بدلالات شريرة. إن اتهام شخص ما بأن لديه “أجندة” يعني ضمناً أنه عميل للنفوذ الأجنبي، ويعمل ضد المصالح والقيم الجماعية للمنطقة. أصبحت هذه الكلمة، من بين أمور أخرى، أداة قوية لإسكات المعارضة وخنق النقاش. وقد تم استخدامها لرفض وشيطنة أصحاب الآراء المختلفة، مما أدى فعليًا إلى تضييق نطاق الخطاب السياسي والاجتماعي. لم تخدم هذه الاستراتيجية اللغوية في الحفاظ على الوضع الراهن فحسب، بل أيضًا في تعزيز عقلية الحصار التي صورت الشرق الأوسط على أنه قلعة محاصرة تقاوم التأثير المفسد للغرب.
إن بيئة الشك والاتهامات هذه، والتي عززها قاموس سياسي متأصل بعمق، كان لها تأثيرات دائمة على نسيج مجتمعات الشرق الأوسط. فقد أعاق الحوار، وأعاق التعاون، وربما كان الأمر الأكثر ضرراً هو خنق ظهور أفكار وإصلاحات جديدة. ففي منطقة غنية بالإمكانات، يظل إرث هذا الترسيخ اللغوي، يشكل عقبة كبيرة أمام التفاهم والسلام وتقرير المصير.
إن الفكرة التي أهدف إلى تسليط الضوء عليها هنا ليست مجرد تمرين أكاديمي في تحليل المعجم السياسي، بل هي نظرة نقدية للواقع الذي يواجه الحركات العلمانية في الشرق الأوسط. إن تعزيز العزلة المتعمدة بين الشرق والغرب يشكل مناورة استراتيجية مصممة بشكل معقّد لإدامة حالة من العداء المستمر. ويفيد هذا الموقف العدائي القوى الراسخة – الدكتاتوريات والثيوقراطيات – التي تهيمن على المشهد السياسي في المنطقة، مما يضمن بقاء قبضتها على النسيج الاجتماعي دون منازع.
لقد أتقنت الأنظمة الديكتاتورية منذ فترة طويلة فن بناء العدو، فخلقت بعبعاً، إذا جاز التعبير، لحشد جماهيرها في موقف موحد ضد عدو مشترك. ويخدم هذا العدو “الخيالي” غرضاً مزدوجاً: فهو يصرف الانتباه عن الإخفاقات والمظالم الداخلية، ويستحضر عقلية الحصار التي تبرر التدابير الصارمة باسم الأمن القومي. ومن خلال نسج خطاب مليء بأوهام التهديدات الخارجية، تمكنت هذه الأنظمة من الحفاظ على قبضتها الخانقة على مواطنيها، واستغلال مواردهم وخنق كل أشكال معارضة.
والمفارقة المأساوية في هذا السيناريو هي طمس البدائل الوطنية القابلة للتطبيق. لقد دمرت الديكتاتوريات، من خلال سياسات الأرض المحروقة، المشهد السياسي بشكل فعال، مما ترك فراغاً حيث ينبغي أن تقف حركة وطنية تقدمية حقيقية. وفي هذا الفراغ، صعدت الفصائل الثيوقراطية، خاصة في أعقاب الربيع العربي المضطرب. فقد وضعت هذه الجماعات الدينية، بهياكلها “وأجنداتها” جيدة التنظيم، نفسها باعتبارها البديل الوحيد الممكن للديكتاتوريات القائمة. وكان لرسالتهم المقاومة ضد العدوان الغربي المتصور صدى في منطقة غارقة بالفعل في الشك والعداء تجاه التأثيرات الخارجية.
في العراق على سبيل المثال، استفاد حزب الدعوة الإسلامية من هذه المشاعر لتعزيز نفوذه، بينما في مصر وتونس، استغلت جماعة الإخوان المسلمين الفوضى والسخط لتأكيد سلطتها. وقد قدمت هذه الحركات نفسها باعتبارها أبطالاً لإرادة الشعب، ووعدت بشكل من أشكال الحكم الذي يحترم الأعراف الثقافية والدينية للمجتمع في حين تقدم ظاهرياً الطريق إلى قدر أكبر من الانفتاح والتعاون مع المجتمع الدولي. وكان المتوقع أن تتبع سوريا أيضاً هذا المسار، في ظل بديل ثيوقراطي مماثل ينهض من رماد الصراع.
وتبرز هذه الديناميكية التحدي الحاسم الذي يواجه الحركات العلمانية في الشرق الأوسط. إن خطاب الشرق مقابل الغرب، الذي تستمر الأنظمة الاستبدادية باستخدامه، لم يؤجج الانقسام فحسب، بل همّش أيضًا بشكل فعال تلك الأصوات التي تدعو إلى مسار ثالث – وهو المسار الذي يسعى إلى التقدم والشمولية والإصلاح الحقيقي دون عبء العقيدة الدينية أو الاستبدادية. إن كسر هذه الحلقة من العداء والشك يتطلب جهداً متضافراً لتقديم العلمانية ليس كرفض للهوية الثقافية ولكن كإطار لبناء مجتمعات ديمقراطية شاملة قادرة على الإبحار عبر تعقيدات العالم الحديث.
ما أحاول عرضه هنا هو فهم دقيق للمصالح الغربية في الشرق الأوسط، والذي يختلف عن الروايات التبسيطية في كثير من الأحيان والتي هيمنت على الخطاب الإقليمي. إن التأكيد على أن الغرب، بشكل عام، يعطي الأولوية للتعاون وإنشاء مجتمع عالمي مترابط، يسلط الضوء على اختلال جوهري مع السرديات التي تروج لها الأنظمة الديكتاتورية وأنصار الإسلام السياسي في المنطقة.
لقد تركزت سياسات الدول الغربية، وخاصة الخارجية منها، بشكل متزايد على تعزيز الشراكات الدولية التي تتجاوز الانقسامات الأيديولوجية. وهذا النهج عملي، ويهدف إلى تأمين المصالح المتبادلة في الاستقرار، والتنمية الاقتصادية، واحتواء التهديدات التي تتجاوز الحدود الوطنية، مثل الإرهاب. ويؤكد ذكر مقابلة تلفزيونية أجرتها شبكة سي إن إن يوم أمس مع عضو جمهوري في الكونغرس على هذه النقطة؛ حيث أكّد عضو الكونغرس “إن التركيز على بناء تحالفات مع كل من المسلمين السنة والشيعة لمكافحة الإرهاب يوضح الرغبة في بذل جهود تعاونية بدلاً من اتخاذ موقف طائفي أو أيديولوجي.”
يتحدى هذا التوجه الاستراتيجي الخطاب القائل بأن الغرب يعارض بطبيعته المجتمعات الإسلامية أو أنه يسعى إلى فرض إرادته على الشرق الأوسط. بدلا من ذلك، فإنه يشير إلى الاعتراف بالنسيج المعقد من المصالح والمعتقدات والفصائل داخل المنطقة والاستعداد للعمل مع مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة لتحقيق أهداف مشتركة. وأنا استنكر بشدة ما تتصوره فصائل معينة داخل الحركة العلمانية في الشرق الأوسط لأنها تحمل توقعات غير واقعية حول دور القوى الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، في تشكيل المشهد السياسي في المنطقة. إن التوقعات بأن رئاسة دونالد ترامب ستغير بشكل كبير سياسة الولايات المتحدة لمعارضة الإسلام السياسي بقوة تعكس سوء فهم لأهداف السياسة الخارجية الأمريكية والقيود المفروضة على التأثير الخارجي على القضايا الراسخة في المنطقة.
من خلال ما تقدم أنا أحاول الإشارة إلى الشعور بالضيق العميق داخل أجزاء من الحركة العلمانية، وهو الشعور باليأس والاعتماد على المنقذين الخارجيين لتصحيح التحديات التي تواجهها المنطقة. أنا أنتقد مثل هذا الموقف ليس فقط باعتباره غير واقعي، ولكنه أيضًا مؤشر على ضعف عميق ونقص في المبادرة لتعزيز التغيير الداخلي. منبّهاً إلى ضرورة إيجاد حلول داخلية تعالج الأسباب الجذرية لصراعات المنطقة مع الاستبداد والتطرف. وهذا يعني ضمناً أن التقدم الحقيقي سوف يأتي من التغيير الذي يمكن ان تحدثه شعوب المنطقة، التي يتعين عليها أن تبحر على طريق بين طرفي النقيض من الدكتاتورية والثيوقراطية نحو مستقبل يحتضن الانفتاح والديمقراطية والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي.
وللتوضيح فإنّ التحدي المحوري الذي تواجهه الحركات العلمانية في الشرق الأوسط هو عدم القدرة على التواصل بشكل فعال وتعزيز رؤية علمانية تنال إعجاب الجماهير المحلية والدولية. ولا يقتصر الانتقاد على الفشل في مواجهة خطابات الإسلام السياسي وتأثيره فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الفشل الأوسع في صياغة بديل مقنع يتوافق مع مبادئ المواطنة، والشراكة الدولية والانفتاح.
إن الانقسام القائم بين الاستسلام لوجود سلبي يتسم بالهروب الاجتماعي وضرورة التعبئة حول أجندة علمانية متماسكة يستعرض الأزمة الوجودية داخل هذه الحركات. فهو يسلط الضوء على منعطف حاسم حيث يتعين على العلمانيين أن يقرروا ما إذا كان عليهم التراجع إلى اللامبالاة أو إعادة وضع أنفسهم بشكل حازم كمهندسين قادرين على البقاء لمستقبل مجتمعاتهم.
ولتجاوز هذا المأزق، فإن الدعوة إلى العمل هي أن يجتمع العلمانيون، مجازاً، على “مائدة مستديرة علمانية”. فيحرقون قاموس سياسة الشرق الأوسط بأكمله، وسيكون هذا المنتدى بمثابة بوتقة لتطوير أجندة متكاملة تعطي الأولوية للمواطنة – مما يعني الالتزام بالقيم الديمقراطية الشاملة وحقوق جميع الأفراد بغض النظر عن الهويات الدينية أو العرقية. علاوة على ذلك، يشير التركيز على الشراكة الدولية والانفتاح إلى الاعتراف بالطبيعة المترابطة لعالم اليوم. وهي تدعو إلى السياسات والمواقف التي تحتضن التعاون العالمي، سواء في الاقتصاد أو القضايا البيئية أو الأمن أو التبادلات الثقافية، باعتبارها ضرورية لمعالجة التحديات المتعددة الأوجه التي تواجه الشرق الأوسط.
من خلال هذا النهج سيستطيع العلمانيون أن يُظهروا للعالم الجانب العملي والفوائد المترتبة على التحالف مع القوى العلمانية في المنطقة. ومن خلال تقديم أجندة علمانية ليس باعتبارها قابلة للحياة فحسب، بل باعتبارها أيضاً الأكثر ملاءمة لتعزيز الاستقرار والتقدم والاحترام المتبادل، فإن الهدف يتلخص في إعادة صياغة تصورات المجتمع الدولي وتفاعلاته مع الشرق الأوسط. إنها دعوة للجهات الفاعلة العالمية إلى اعتبار العلمانيين شركاء موثوقين ومفضلين على الكيانات المرتبطة بالإسلام السياسي، والتي غالبًا ما تكون لها أجندات تتعارض مع القيم الديمقراطية الليبرالية والأعراف الدولية.
في جوهرها، ترتكز هذه الرؤية لحركة علمانية متجددة على الاعتقاد بأن التغيير الهادف في الشرق الأوسط يتطلب أساسًا من القيم الداخلية القوية والتحالفات الخارجية. وهو يدعو إلى إعادة تصور عميق للدور الذي يلعبه العلمانيون في مجتمعاتهم – ليس كمتفرجين محبطين ولكن كمساهمين استباقيين في مستقبل يحتضن التنوع والحرية والمشاركة العالمية. ومن خلال القيام بذلك، فهو يفترض أن العلمانية في الشرق الأوسط يمكن أن تتجاوز حدودها الحالية وتبرز كقوة رائدة للتحول الإيجابي.
إن هذه الدعوة إلى الوحدة والإصلاح في المشهد السياسي والاجتماعي في الشرق الأوسط هي نداء من أجل إحداث تحول جذري في العقلية والنهج بين أولئك الذين يسعون إلى التغيير. ويؤكد ضرورة تفكيك الانقسامات الأيديولوجية والطائفية الراسخة التي أدت تاريخيا إلى تفتيت الجهود المبذولة لتحقيق التقدم والاستقرار. أمّا استخدامي أعلاه لمصطلح الحرق المجازي لـ “قاموس سياسة الشرق الأوسط بأكمله” فهو يمثل رفضًا جريئًا للأطر والمصطلحات والخطابات القائمة التي أدت إلى إدامة الانقسام وأعاقت إنشاء مجتمع أكثر ديمقراطية وشمولاً.
أمّا تركيزي على المواطنة كمبدأ أساسي لإعادة البناء إلى التحرك نحو هوية أكثر علمانية ومدنية، تتجاوز الانتماءات الدينية والعرقية والطائفية، فأنا أحاول أن أبرز الأولوية للحقوق والمسؤوليات والمساواة بين جميع الأفراد بموجب القانون، داعياً إلى مجتمع لا تتوقف فيه قيمة الفرد وحقوقه على معتقداته الدينية أو عدم وجودها. إنها رؤية لمجتمع حيث الصالح العام، ضمن معايير المساواة القانونية والمدنية، يوجه العمل السياسي والاجتماعي.
وينطوي هذا الطرح أيضًا على تحول ثقافي وتعليمي كبير. فهو يستلزم تعزيز الوعي العام الذي يقدر التنوع، ويدعم التعددية، ويرفض الطائفية بشكل فعال. ويصبح تثقيف المواطنين حول مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وأهمية المشاركة المدنية أمرًا بالغ الأهمية في هذا المسعى. ولا يقتصر هذا التعليم على الأطر الرسمية، بل يمتد إلى جميع مجالات الحياة العامة، ويشجع ثقافة الحوار والتسامح والاحترام المتبادل.
علاوة على ذلك، فإن الدعوة إلى الاجتماع على طاولة واحدة، ورفض مزاعم الأولوية والتبعية، هي دعوة للشمولية والتعاون. فأنا أدرك أن الطريق إلى الأمام يجب أن يتم تمهيده من خلال الجهد الجماعي، حيث يتم تقدير الأصوات ووجهات النظر المتنوعة بدلاً من تهميشها. ويتطلب هذا المسعى الجماعي آليات للحوار وصنع القرار تعكس تنوع المجتمع الذي يهدف إلى تمثيله، مما يضمن أن يكون لجميع أصحاب المصلحة رأي في تشكيل المستقبل.
والنتيجة المتصورة لهذا الإصلاح الجذري هي نظام سياسي يتم فيه تحديد هوية الدولة ووحدتها من خلال المواطنة المشتركة والالتزام المشترك بدعم القانون وضمان العدالة للجميع. فهو يتصور الشرق الأوسط حيث يتجدد العقد الاجتماعي، وترتكز شرعية الدولة على قدرتها على ضمان حقوق ورفاهية كل مواطن، بغض النظر عن معتقداته أو هوياته الشخصية. وفي جوهرها، أنا أدعو إلى رحلة تحويلية نحو إنشاء شرق أوسط أكثر شمولاً وإنصافاً وديمقراطية.