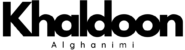عولجت قوانين ازدراء الاديان سيئة الصيت مرات عديدة وعديدة، من قبل جمع غفير من الكتاب والمؤسسات الدولية سواء حقوقية ام انسانية. وانا هنا لست لأعيد ما كتبه غيري في هذا الشأن، أنا هنا اسعى الى لفت النظر لحقيقة قد لا تغقل عن الكثيرين ولكنها لم تعالج بشكل سليم ولم يسلط عليها الضوء بشكل كامل، وهي ان واقع
قوانين ازدراء الاديان ليست بالشئ الجديد بل هو واقع ديني متأصل ومتجذر لمئات السنين، فالكنيسة هرطقت من قال بكروية الارض، وأحرقت بالنار من أشار الى ان الارض ليست مركز الكون، ولم يختلف الامر كثيرا مع حجاج الصحراء حيث قطعوا رؤوس كل المرتدين عن دينهم وقطعوا من خلاف ارجل وايادي كل من صرح بافكارٍ تتناقض مع شرائعهم بتهمة الافساد في الارض، ولا أقلَ من تهمة انكار ماهو معلوم من الدين بالضرورة لتكون كافية بحصولك على وسام التكفير مع مرتبة الشرف.
من خلال هذه اللمحة التاريخية أودّ التذكير بالعواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجم عن قوانين إزدراء الأديان، مما يعكس زمناً كان مجرد التشكيك في الروايات الدينية السائدة أو التعبير عن آراء معارضة يؤدي إلى عقوبات شديدة تصل الى الحكم بالاعدام في أحيان كثيرة. ولم تقتصر هذه الممارسات على دين أو منطقة معينة، بل كانت شائعة بين مختلف السلطات الدينية التي سعت إلى الحفاظ على سلطتها وسيطرتها من خلال قمع أي شكل من أشكال التحدي لمعتقداتها العقائدية.
من خلال إشارتي إلى اضطهاد الكنيسة للأفراد بسبب تأييدهم لنظريات مركزية الشمس، فضلاً عن التدابير القاسية التي يتخذها الزعماء الدينيون في سياقات أخرى ضد أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم مرتدون أو زنادقة، أريد أن أسلط الضوء على التاريخ الطويل لقوانين إزدراء الأديان كأدوات لخنق الحرية الفكرية ومعاقبة المعارضة . تؤكد هذه الخلفية التاريخية على أهمية إجراء فحص نقدي وتحدي لقوانين إزدراء الاديان المعاصرة التي تستمر في قمع حرية التعبير ومعاقبة الأفراد بسبب معتقداتهم أو عدمها.
إن الدعوة إلى معالجة قضية قوانين إزدراء الأديان اليوم ليست مجرد دعوة للإصلاح القانوني؛ إنها دعوة إلى تحول مجتمعي أعمق نحو احتضان التنوع الفكري، وحماية حرية المعتقد، وتعزيز بيئة لا يتم فيها التسامح مع التساؤل والتفكير النقدي فحسب، بل يتم تشجيعهما أيضًا. يتعلق الأمر بالاعتراف بالقيمة الجوهرية لحق كل فرد في التعبير عن أفكاره ومعتقداته دون خوف من الاضطهاد أو العنف.
أضف الى ذلك أنّ لفت الانتباه إلى هذه القضية، فإن الهدف ليس فقط انتقاد وجود وتطبيق قوانين إزدراء الأديان، ولكن أيضًا الدعوة إلى عالم أكثر شمولاً وتسامحًا حيث يُنظر إلى تنوع الفكر والمعتقدات البشرية على أنه قوة وليس تهديدًا. ويتطلب ذلك جهدًا جماعيًا للدفاع عن القوانين والسياسات التي تحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير، فضلاً عن الالتزام بالتثقيف والتوعية حول مخاطر السماح لهذه الممارسات القمعية بالاستمرار دون منازع.
وعلى كلٍّ، على أرض الواقع نرى الأزهر السني والحوزة الشيعية يقومان بتكفير كل من يشير سواء بعلامة إستفهام أو بعلامة تعجب على تصرف صدر من أسوتهم الحسنة أو من عشرتهم المبشرة بالجنة أو من أئمتهم المعصومين.
لا أريد أن أشير إلى عديد الأسماء التي تم تصفيتها بحسب فتاوى إزدراء الأديان فالقائمة طويلة ولن تكفيها هذه السطور. آخرها شهيد الأردن ناهض حتّر، ولن تنته هذه القافلة قريباً. سنظل نرى حتّر آخر وسنظل نرى فودة جديد وسنظل نرى ابن مقفعٍ اخر.
السؤال كيف سنوقف ما يحدث؟ هذا السؤال هو الأكثر إلحاحا بين المفكرين والمثقفين، فبين من يهاجمون الإسلام والأديان بشكل عام باعتبارها الأزمة الحقيقية، وبين من يلقون اللوم على المؤسسة الدينية، وبين من ينظرون إلى القضية على أنها مجرد تقليد اعتمدته مجتمعاتنا للتعامل مع الخلافات.
أنا هنا لا ألقي اللوم على أي طرف؛ بل أرى أن جزءاً لا يستهان به من المسؤولية يقع على عاتقنا، “نحن الذين يدعون الفكر والثقافة”. نحن المتخلفون الحقيقيون في هذا السيناريو. كل أيديولوجية تدافع عن نفسها بطريقتها الخاصة، وكانت محاكم التفتيش هي الطريقة الأمثل التي تمارسها الأديان تحت ستار الأساطير المقدسة. ولكن على مر التاريخ، ماذا فعلنا بخلاف التعبير عن التضامن؟
وهذا التفكير ليس إدانة، بل دعوة للمجتمع الثقافي للعمل. ونحن، الذين نفتخر بفكرنا وثقافتنا، يجب علينا أن نواجه سلبيتنا. فكثيراً ما لجأت الإيديولوجيات، المتسترة بعباءة الشرعية التي تمنحها التقاليد الدينية أو الثقافية، إلى اتخاذ تدابير صارمة للحفاظ على هيمنتها. إن محاكم التفتيش التاريخية، تحت هالة القداسة الإلهية، تجسد الحدود القصوى التي يمكن الدفاع عن العقيدة بها.
ومع ذلك، وبينما ننتقد هذه التجاوزات الماضية، يتعين علينا أيضًا أن نفحص استجاباتنا المعاصرة للقمع الأيديولوجي والتعصب. إلى جانب التعبير عن التضامن مع أولئك الذين يعانون تحت نير محاكم التفتيش في العصر الحديث، ما هي الإجراءات الجوهرية التي اتخذناها؟ فهل تحدينا الوضع الراهن بنفس الحماس الذي نحلله ونناقشه في الأوساط الأكاديمية والمنتديات الفكرية؟
يكمن النقص الحقيقي في فشلنا في ترجمة المعارضة الفكرية إلى تغيير مجتمعي حقيقي. ورغم أن الأيديولوجيات طورت آليات للحفاظ على الذات، غالبا من خلال القمع والإقصاء، فإن تدابيرنا المضادة ظلت في كثير من الأحيان محصورة في المجال النظري. التحدي إذن لا يتمثل في تحديد ونقد مصادر التعصب الأيديولوجي فحسب، بل في المشاركة بنشاط في تفكيك الهياكل التي تدعمها.
وهذا ينطوي على نهج متعدد الأوجه يتجاوز مجرد النقد. فهو يتطلب منا أن نستفيد من ادعاءاتنا الفكرية والثقافية للتأثير على السياسات، وتثقيف عامة الناس. ويدعو إلى الالتزام بالمشاركة العملية، حيث يتم الدفاع عن المثل العليا لحرية التعبير والتعددية الأيديولوجية ليس فقط بالكلمات ولكن من خلال الإجراءات المنسقة التي تتحدى المؤسسات والتقاليد التي تديم التعصب.
في جوهر الأمر، فإن المسؤولية التي نتحملها كمثقفين ومناصرين للثقافة عميقة. فهو يتطلب منا بذل جهد مخلص لتجاوز مرحلة التضامن، والمشاركة بنشاط في تشكيل عالم حيث يتم تحويل محاكم التفتيش في الماضي والحاضر إلى التاريخ، ويحل محلها التزام حقيقي بالحوار والتفاهم والتبادل غير المقيد للأفكار. عندها فقط يمكننا أن ندعي أننا ساهمنا حقاً في وقف دورة القمع الإيديولوجي والتعصب التي ابتليت بها مجتمعاتنا.
علينا أن ندرك أنه عندما يقتل المجرمون شخصيات مثل حتّر أو فودة أو كثيرين غيرهم، فإن هدفهم لا يقتصر على هؤلاء الأفراد فحسب. الهدف هو تحطيمنا نحن من بقي من المثقفين والمفكرين. الهدف هو تكسير عظامنا نحن وتحطيم أقلامنا وزرع بذور الخوف فينا. فكم منّا أعلن البيعة لـ “لا إله إلا الله” فقط لحماية عائلاتنا؟ كم منا اختبأ وراء أسماء مستعارة لحماية أنفسنا وأحبائنا من طغيان أتباع الخرافات؟
الخيار ليس على طاولتهم أيها السادة. بل إنه على طاولتنا نحن. فبالنسبة لهم فهم ليس لديهم خيار سوى اتباع ما يمليه عليهم دينهم المقدس. أمّا من ناحيتنا نحن، فنحن الذين يملكون الخيار. الخيار بين الاعتراف الكامل بالهزيمة، وإنهاء عهد فودة وحتّر وغيرهما، أو العيش حياة آمنة ولكن مهينة، أو التوحد في بناء جبهة مشتركة كبيرة ودقيقة، فيرى خصومنا ثقلنا وقوتنا، مما يجعلهم يفكرون ألف مرة قبل اتخاذ خطوة واحدة ضدنا.
إن الدعوة إلى العمل ليست مجرد موقف دفاعي، بل هي تعبئة استراتيجية للموارد الفكرية والثقافية. فالطريق إلى الأمام لا يمر عبر الاستسلام أو العزلة، بل عبر العمل الجماعي الميداني الصادم. إن التركيز على الوحدة وبناء “جبهة مشتركة” هو اعتراف بأن القوة تكمن في الإعداد وفي الالتزام المشترك بالدفاع عن مساحة الخطاب النقدي المعارض.
ولا تهدف هذه الاستراتيجية إلى البقاء فحسب، بل إلى تغيير الظروف التي يعمل في ظلها المثقفون. يتعلق الأمر بتكوين قوة جماعية قادرة على مواجهة التهديدات وضمان ازدهار المجتمع الفكري دون خوف دائم من القمع. ويعترف هذا النهج بالتفاعل المعقد بين القوة والخوف والمقاومة، ويقترح أن الترياق للترهيب والعنف ليس الصمت، بل زيادة الرؤية والتضامن والقدرة على الصمود.
ما يحدث بشكلٍ مستمر هو دليل ثابت على ضرورة العمل المشترك والمنسق بأسلوب مؤسسي وبشكل دولي، فلن يقف معنا أحد غيرنا نحن، لن تقف معنا حكوماتنا الدكتاتورية الأبوية في الشرق الأوسط، تلك الارض التي فقدت كيانها بالكامل حينما زرع أول أسير يهودي في بابل خرافة اسماها “الله”… لتبدأ مع تلك الكذبة مسلسل كبير لخسائر الحضارات العظمى في الشرق الأوسط.
يجب ان نعلن هنا انتهاء مرحلة تكسير العظام ويجب أن نبدأ مرحلة جديدة من صراعنا مع الجهل. يجب أن نبدأ بلملمة شملنا نحن.
تأبى العظام اذا اجتمعن تكسراً وإذا أفترقن تكسرت آحادا
سنستمر بمدِ يدنا لكل المثقفين ولكل المفكرين الذين يحبون أنسانيتهم ويسعون لبناء مستقبل أجمل لأبنائهم، أخوتكم في العقل الحر بانتظاركم يا سادة.