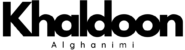بعد يومين فقط، ستجد الولايات المتحدة نفسها عند مفترق طرق سياسي، مع استحواذ الانتخابات الرئاسية على الاهتمام العالمي. يبقى الشرق الأوسط، على وجه الخصوص، يراقب بفارغ الصبر، مدركاً تمام الإدراك كيف يمكن أن تؤثر النتيجة على منطقة متشابكة في الصراع، وتطلعات العديد من الاحزاب والمنظمات السياسية إلى الديمقراطية والعلمانية. لقد عرض المرشحان، دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، تناقضات صارخة في المزاج والسياسة، الأمر الذي جعل الكثيرين يتساءلون عن مستقبل السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط.
موقف دونالد ترامب والشرق الأوسط
لم يكن الخطاب الذي أحاط بحملة دونالد ترامب مجرد ظاهرة، فقد تميزت حملته بجو من القوة المغناطيسية استحوذت على الاهتمام العالمي. بمزيج من الثقة الجريئة والجاذبية الغامضة، تحدى النهج الذي اتبعه ترامب “المرشح الجمهوري” في التعامل مع السياسة الأعراف والتوقعات التقليدية. وكان موقفه الثابت بشأن مكافحة الإرهاب الإسلامي، إلى جانب الوعود بإعادة تقييم الاتفاق النووي الإيراني وربما تفكيكه، بمثابة مثال على الجرأة التي ضربت على الوتر الحساس لدى الكثيرين، وخاصة أولئك الذين شعروا بالحرمان من حقوقهم في النظام السياسي القائم.
تثير خلفية ترامب غير التقليدية، الخالية من الخبرة السياسية أو العسكرية التقليدية المرتبطة عادة بالمرشحين الرئاسيين، تساؤلات ومخاوف مشروعة حول فهمه للمناظر الجيوسياسية المعقدة. ومع ذلك، فإن هذا الافتقار إلى التقليدية هو ما أدى إلى تضخيم جاذبيته، وتقديمه كشخص خارجي يرغب في تحدي الوضع الراهن. إن خطابه، الذي اتسم بالصراحة والقوة، لم يجذب الانتباه فحسب، بل أثار أيضًا مزيجًا قويًا من المشاعر في جميع أنحاء العالم.
وفي الشرق الأوسط، قوبلت خطابات ووعود حملة ترامب الانتخابية بمزيج معقد من ردود الفعل. حيث ينظر البعض إلى مواقفه الحازمة بقدر من التفاؤل، على أمل إحداث تغيير في ما اعتبروه سياسة خارجية أمريكية راكدة أو مضللة تجاه المنطقة. ومع ذلك، يتعامل آخرون مع ترشيحه بإحساس واضح بعدم اليقين والقلق، متفكرين فيما إذا كان نهجه يدل على خروج حاد عن الدبلوماسية التقليدية أو بداية حقبة جديدة، وإن كانت لا يمكن التنبؤ بها، من المشاركة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط.
على الرغم من تنوع ردود الفعل، كان هناك جانب واحد واضح بشكل لا لبس فيه: أثار ظهور ترامب كمنافس رئاسي هائل مستوى غير مسبوق من الحوار والتأمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقد أدى ترشيحه إلى إعادة تقييم الافتراضات القائمة منذ فترة طويلة حول السياسة الخارجية للولايات المتحدة واتجاهها المستقبلي. وسواء نظرنا إلى وجود ترامب على الساحة العالمية بتخوف أو بتفاؤل حذر، فإنه لا شك أن حضوره على الساحة العالمية أشعل خطابا تجاوز الحدود، وهو ما يعكس العواقب العميقة والواسعة النطاق التي خلفتها الانتخابات الرئاسية الأميركية على الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط. وفي خضم هذه الدوامة من النقاش والتكهنات، وجدت المنطقة نفسها على مفترق طرق، وهي تفكر في تداعيات رئاسة ترامب على مشهدها المعقد والمتقلب في كثير من الأحيان.
نهج هيلاري كلينتون تجاه الشرق الأوسط
يعدُّ ترشح هيلاري كلينتون للرئاسة سبباً في تسليط الضوء على شخصية تتمتع بقدر كبير من المعرفة والتأثير العميق، والتي شكلتها مسيرة مهنية واسعة ولامعة في السياسة، وأبرزها فترة عملها كوزيرة للخارجية. تركت هذه الفترة من الخدمة علامة لا تمحى على شخصيتها العامة، حيث أظهرت مزيجًا من البراعة الدبلوماسية والمشاركة العميقة في الشؤون العالمية. وقد احتفل الكثيرون بمخزونها الغني من الخبرة كدليل على كفاءتها وخبرتها، مما صورها كمرشحة تتمتع باستعداد لا مثيل له للقيادة على الساحة الدولية.
ومع ذلك، فإن سجل كلينتون يقدم نفسه أيضًا على أنه سلاح ذو حدين، خاصة عندما يُنظر إليه من خلال عدسة الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط. وقد أشاد المعجبون بكلينتون بتجربتها وفهمها الدقيق للعلاقات الدولية، حيث رأوا فيها زعيمة قادرة على الإبحار في التيارات المعقدة للدبلوماسية العالمية بيد ثابتة. ومع ذلك، أشار المنتقدون إلى حالات محددة في حياتها المهنية، مثل دعمها للتدخل العسكري في ليبيا ومواقفها من الحرب الأهلية السورية، كدليل على ميلها التدخلي المحتمل الذي أثار قلقًا كبيرًا. وزعم هؤلاء المنتقدون أن مثل هذه القرارات، التي ترمز إلى موقف التدخل الأوسع، قد تنبئ باستمرار السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي.
وأضاف الإرث الجدلي لإدارة أوباما، التي خدمت كلينتون في ظلها، المزيد من التعقيد للتصورات حول ما قد تنطوي عليه رئاستها بالنسبة للشرق الأوسط. بالنسبة للبعض، تمثل جهود الإدارة محاولة صادقة، وإن كانت معيبة في بعض الأحيان، للتعامل مع المنطقة بطريقة بناءة. وبالنسبة لآخرين، فإن نتائج سياساتها – في أماكن مثل سوريا وليبيا، وفي السياق الأوسع للربيع العربي – كان يُنظر إليها على أنها أوجه قصور أثارت تساؤلات حول مدى فعالية النهج الدبلوماسي الذي قد تستمر فيه كلينتون أو تعدله.
تثير وجهات النظر المتناقضة هذه مناقشات ساخنة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، حيث كان الناس يفكرون في العواقب التي قد تترتب على رئاسة كلينتون المحتملة. لقد تجاوزت المناقشات مجرد الانتقادات أو التأييد، وتعمقت في تحليلات أعمق لاستراتيجيات السياسة الخارجية، والنهج الدبلوماسي، وجوهر المشاركة الأمريكية في المنطقة. بالنسبة للكثيرين، كان احتمال قيادة كلينتون حافزًا لتأملات أوسع حول مستقبل الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، ودور الولايات المتحدة في تشكيل ذلك المستقبل، والحاجة الماسة إلى سياسات مستنيرة ودقيقة تأخذ في الاعتبار الحقائق المعقدة في المنطقة.
واقع محدوديات السياسة الخارجية الأمريكية
تواجه الولايات المتحدة، على الرغم من نفوذها العالمي الكبير وقوتها العسكرية، تحديات كبيرة في إحداث تغيير جوهري في الشرق الأوسط، وهو الواقع الذي يؤكده خطاب الانتخابات الرئاسية في عام 2016. وهذا القيد ليس مجرد مسألة إرادة سياسية أو رؤية لأي إدارة بعينها، بل إنه انعكاس للشبكة المعقدة من العوامل البنيوية والجيوسياسية التي تحدد المشهد العام في المنطقة.
ترجع جذور التعقيد الجيوسياسي في الشرق الأوسط إلى شبكة كثيفة من التحالفات، والخصومات، والمظالم التاريخية التي تجعل من الصعب للغاية على القوى الخارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن تبحر عبرها. هذه التحالفات ليست ثابتة ولكنها تخضع للديناميكيات المتغيرة للسياسة الإقليمية والنظام الدولي الأوسع. وتؤدي أهمية الموارد النفطية إلى زيادة الأمور تعقيداً، حيث أن اعتماد الاقتصاد العالمي على نفط الشرق الأوسط يمنح المنطقة أهمية كبيرة على المسرح العالمي. وقد أدى هذا تاريخياً إلى شكل من أشكال التناقض الجيوسياسي، حيث غالباً ما تتعارض الرغبة في الاستقرار والوصول إلى الموارد مع السعي لتحقيق المثل الديمقراطية وحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المصالح الخاصة للقوى العالمية الكبرى الأخرى في المنطقة، مثل روسيا والصين، تعمل بمثابة حواجز هائلة أمام الإجراءات الأمريكية الأحادية الجانب. فلهذه الدول أهدافها الإستراتيجية الخاصة في الشرق الأوسط، والتي تتعارض في كثير من الأحيان مع المصالح الأمريكية. إن وجود هذه القوى لا يؤدي إلى تعقيد الحسابات الجيوسياسية فحسب، بل يحد أيضًا من نطاق نفوذ الولايات المتحدة، حيث يجب أن تتعارض الجهود الرامية إلى تغيير الوضع الراهن مع التدابير المضادة والسياسات التي تتخذها هذه الجهات الفاعلة المهمة الأخرى.
ربما تمثل التعقيدات الداخلية داخل دول الشرق الأوسط نفسها التحدي الأكبر للتدخلات أو التأثيرات الخارجية. إن بلدان المنطقة ليست متجانسة، بل إنها تتميز بنسيج غني من التنوع الثقافي والديني والسياسي. وهذا التنوع يعني أنّ السياسات أو التدخلات المصممة وفق نهج واحد يناسب الجميع من المرجح أن تواجه مقاومة شرسة. تمتلك المجتمعات في الشرق الأوسط قدراتها وتطلعاتها الخاصة، وغالباً ما تنظر إلى التدخلات الخارجية بعين الشك أو العداء الصريح، وخاصة إذا نظر إلى مثل هذه التصرفات على أنها انتهاك للسيادة الوطنية أو فشل في احترام الأعراف والتاريخ المحلي.
وتسلط هذه الطبقات من التعقيد الضوء على محدودية قوة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. فأي مسعى يهدف إلى تغيير الوضع الراهن من جانب واحد يجب أن يبحر في متاهة من العوامل المحلية والإقليمية والدولية. إن التحديات ليست مستحيلة، ولكنها تتطلب فهماً دقيقاً للمنطقة، وتقديراً لحدود القوة، والالتزام بالتعددية والمشاركة الدبلوماسية. إن إدراك حقيقة مفادها أن التغيير في الشرق الأوسط لا يمكن توجيهه من الخارج فحسب، بل لابد من رعايته من خلال التعاون، واحترام السيادة، والشراكة الحقيقية مع شعوب المنطقة، يشكل ضرورة أساسية لأي سياسة أميركية في المستقبل.
نداء إلى العلمانيين في الشرق الأوسط
إن السعي إلى إحداث تغيير ملموس في الشرق الأوسط يتطلب اعترافاً عميقاً بأن الحافز للتحول لا يكمن خارج حدودها، بل في قلوب وعقول شعوبها. ويخدم هذا الإدراك بمثابة نداء واضح للعلمانيين والإصلاحيين وكل الملتزمين برؤية منطقة أكثر استقرارا وديمقراطية وازدهارا.
لفترة طويلة جدًا، كان الخطاب يتشكل بناءً على التوقعات ــ أو ربما الأمل ــ بأن القوى الخارجية، مثل الولايات المتحدة، قد تكون مهندسي التغيير الكبير. ومع ذلك، فقد أثبت التاريخ مراراً وتكراراً أن الإصلاح الحقيقي والدائم لا يمكن استيراده أو فرضه؛ بل يجب أن تنبثق عضوياً من داخل المجتمع. وهذا لا يعني استبعاد التأثير الإيجابي المحتمل للتعاون أو الدعم الدولي، بل للتأكيد على أن القوة الدافعة الأساسية يجب أن تكون المبادرة والالتزام المحليين.
وبالتالي فإن الدعوة إلى العمل من جانب العلمانيين والأفراد ذوي العقلية الإصلاحية ذات شقين. أولا، أنها تنطوي على رعاية المبادرات الشعبية التي تعمل على تمكين المجتمعات وتعزيز الشعور بالقدرة على عملية التغيير. ويمكن لهذه المبادرات أن تتخذ أشكالا لا تعد ولا تحصى، من البرامج التعليمية التي تعزز التفكير النقدي والتسامح، إلى المشاريع الاقتصادية التي تعالج الفقر وعدم المساواة، إلى الحملات الإعلامية التي تتحدى الصور النمطية وتشجع الحوار.
ثانياً، يتطلب السعي إلى الإصلاح السياسي والحركات الاجتماعية الشجاعة والمثابرة. فهو ينطوي على تحدي المصالح الراسخة والتعامل مع تعقيدات السلطة السياسية، كل ذلك في حين يدعو إلى سياسات تعزز الشمولية، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون. وهذه ليست مهمة بسيطة، نظراً للعقبات التي تفرضها الأنظمة الاستبدادية، والتقاليد الدينية الباليّة ، والانقسامات الطائفية، والتدخل الخارجي. ومع ذلك، فإن المكافآت المحتملة – السلام والاستقرار والازدهار – هائلة وتستحق الجهد المبذول.
علاوة على ذلك، فإن التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للصراع وعدم الاستقرار يسلط الضوء على الحاجة إلى نهج شامل لا يعالج الأعراض فحسب، بل يعالج القضايا الأساسية. إن التفاوت الاقتصادي، والحرمان السياسي، والظلم الاجتماعي، والانقسامات الثقافية، كلها تحديات مترابطة وتتطلب استجابات مدروسة ومنسقة.
في جوهر الأمر، فإن الرحلة نحو التغيير الهادف في الشرق الأوسط هي رحلة يجب أن ترسمها شعوب المنطقة، من خلال حشد العمل الجماعي ورعاية رؤية مشتركة للمستقبل. ولن يكون المسار سهلاً ومفروشاً بالورود بل بالعكس سيكون المسار محفوفاً بالتحديات والمصاعب، ذلك لأنّ تاريخ المنطقة يشهد على تصلّب وانغلاق شعوبها، وصعوبة تقبلها لعمليات التغيير، وخصوصاً التغييرات الانفتاحية التقدمية والعلمانية. لكن ومن خلال توحيد صفوف المثقفين والعلمانيين والعمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة وتسخير كل قواهم، سيستطيع هؤلاء أن يقودوا الطريق في تشكيل منطقة أكثر تفاؤلاً وديناميكية وشمولاً.