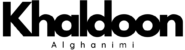أوقفتهم شعوبهم، فلم يعد هناك أي معنى للتغاضي عن دماء أبنائهم، التي سفكت بأطماع العقلية البدوية المتطرفة. لقد استنانوا قانون جاستا لإغلاق تلك الذرائع الشعبية التي لم تعد قادرة على تحمل أي ارتباط أحمق بمثل هذا الحليف. وهذا يلخص ما فعله الشعب الأمريكي لمحاسبة النظام السعودي على إصراره على الحماقات الأصولية.
وانطلاقاً من الحاجة الملحة إلى مواجهة العلاقات الخطيرة التي حصدت أرواح الكثيرين، بدأت المجتمعات في مختلف أنحاء العالم تستيقظ على الحقائق القاسية التي تفرضها التحالفات التي تم تشكيلها تحت ذرائع مشكوك فيها. ويعد سن قانون جاستا (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) من قبل الشعب الأمريكي تجسيدا صارخا لهذه الصحوة – الرفض الشديد لغض الطرف عن الفظائع التي تغذيها أيديولوجية دينية متطرفة.
ويسلط هذا المنعطف الحاسم في العلاقات الدولية الضوء على استياء عالمي أوسع نطاقاً إزاء الوضع الراهن، حيث سُمِح للحكومات والأنظمة، المدفوعة بعقلية عتيقة ومتطرفة، بالعمل مع الإفلات من العقاب. إن المبادرة الأميركية ليست مجرد مناورة قانونية، بل بمثابة بيان عميق ضد إدامة العنف والتطرف تحت حماية الحصانة السيادية.
إن هذه الخطوة الجريئة من جانب الشعب الأميركي، وفي الواقع من قبل أي مجتمع يجرؤ على تحدي أسس مثل هذه التحالفات الخطيرة، تشير إلى تحول محوري. إنها دعوة واضحة لإعادة تقييم الشراكات التي زرعت بذور الخلاف والعنف بدلاً من تعزيز السلام والاحترام المتبادل. إنه نقد صارم وقاس للطريقة التي يعالج بها المجتمع الدولي الأسباب الجذرية للإرهاب والتطرف.
علاوة على ذلك، فإن هذا التحدي التشريعي هو شهادة على قوة صوت الشعب في تشكيل السياسة الخارجية ومحاسبة قادتهم، بل وأيضاً الأنظمة الأجنبية على أفعالهم. إنه تذكير بأن عواقب تعزيز التطرف أو التسامح معه لا تقتصر على الحدود الوطنية، بل لها آثار بعيدة المدى يمكن أن تمس حياة المواطنين في جميع أنحاء العالم.
في جوهر الأمر، يمثل سن قانون جاستا والتدابير المماثلة على مستوى العالم موقفًا جماعيًا حاسمًا ضد تطبيع التطرف تحت ستار دبلوماسي. إنه موقف صارم وحاسم يقتضيه العصر، ويعكس إجماعاً متزايداً على أن الحرب ضد الإرهاب ورعاته لا تتطلب القوة العسكرية أو العمليات الاستخباراتية فحسب، بل تتطلب أيضاً إطاراً قانونياً وأخلاقياً قوياً يتجاوز المصالح الوطنية من أجل الأمن العالمي والرخاء العالمي.
ليس من الضروري أن يلتزم الشعب الأمريكي بالعلمانية للمطالبة بمحاسبة الأصوات المتطرفة داخل السعودية. يكشف الواقع أن المجتمع الأمريكي نفسه يتصارع مع اتجاهات أصولية كبيرة، حيث يُعزى نجاح وقوة المرشح الأمريكي ترامب إلى دافع أصولي أو خصائص الدوافع الدينية أو المحافظة لدى شرائح من الشعب الأمريكي.
ومع ذلك، فإن صدور قانون جاستا وصعود التيارات اليمينية في العديد من الدول الغربية لا يعنيان سوى فشل العلمانية في التعامل مع الأصوليات بجميع أنواعها. وهنا، أستطيع أن أزعم أن العلمانية في الغرب لم تكن علمانية في جوهرها أبدًا، بل كانت بالأحرى مجموعة من الحركات والتوجهات الليبرالية التي فشلت في فهم خطر الأصولية المدفونة بين سكانها.
تشير هذه الملاحظة النقدية إلى سوء فهم عميق في قلب الفكر السياسي الغربي: الافتراض بأن الأطر الليبرالية العلمانية مجهزة بطبيعتها لتحييد تهديد الأيديولوجيات الأصولية. ويؤكد صعود شخصيات مثل ترامب والزخم الذي اكتسبته الإيديولوجيات اليمينية في مختلف أنحاء الغرب على الاستياء الواضح ــ التوق إلى الهوية والتقاليد في مواجهة العولمة السريعة والضعف الثقافي الملحوظ.
ومن ثم، فإن المطالبة الأمريكية بمحاسبة المملكة العربية السعودية لا تمثل رواية مباشرة عن مجتمع علماني يواجه التطرف الديني في الخارج. بل هو بدلاً من ذلك نسيج معقد من التناقضات الداخلية، حيث يواجه المجتمع تياراته الأصولية الخفية في حين يتحدى أولئك الذين يعيشون في الخارج. يكشف هذا السيناريو القيود المفروضة على النهج العلماني البحت في الحكم والتنظيم المجتمعي، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى فهم أكثر دقة للتفاعل بين العلمانية والأصولية والليبرالية.
وفي ضوء ذلك، فإن سن قانون جاستا ليس مجرد استجابة قانونية للإرهاب، بل هو مظهر من مظاهر الانقسامات المجتمعية الأعمق والنضال من أجل التوفيق بين الهوية الوطنية والمسؤوليات العالمية. وعلى نحو مماثل، لا يعكس صعود التيارات اليمينية رفضاً كاملاً للعلمانية، بل يعكس انتقاداً لعدم كفاءتها في معالجة القضايا الأساسية التي تؤدي إلى ظهور المشاعر الأصولية.
وفي جوهر الأمر فإن المواجهة الغربية مع الأصولية، سواء في الداخل أو في الخارج، تدعو إلى إعادة تقييم النموذج العلماني الليبرالي. وهو يتطلب تفكيرا أعمق في الكيفية التي يمكن بها للمجتمعات تعزيز هوية شاملة تستوعب التنوع والمعارضة دون الوقوع في فخاخ التطرف. وهذا التحدي لا يقتصر على الغرب؛ إنها حتمية عالمية، تضغط على المجتمعات في كل مكان لصياغة مسارات جديدة للتعايش تتجاوز التناقضات الثنائية بين العلمانية والدينية، والحديثة مقابل التقليدية.
وعندما ندعو إلى القضاء على الأصولية الدينية، فإننا ندعو في الوقت نفسه إلى القضاء على جميع أشكال الأصولية، حتى لو ظهرت في ملابس السباحة. الأصولية لا تلبس بالضرورة رداءً قصيراً، أو عمامة سوداء أو بيضاء، أو حتى تحمل صليباً.
علينا جميعا أن نعيد تقييم مواقفنا ونقف أمام مرآة حكومة ضميرنا أولا وأخيرا. هل نحن علمانيون حقًا كما ينبغي أن نكون؟ هل نرقى إلى مستوى مطالبنا؟ هل نحن علمانيون أم أننا أصوليون متخفون بثوب علماني؟
يتطلب هذا التأمل فحصًا صارمًا لمعتقداتنا وممارساتنا، مما يشكل تحديًا لنا لتمييز الخط الدقيق بين العلمانية والأصولية. إنها دعوة للاعتراف بأن الأصولية لا تقتصر على العلامات الواضحة للزي أو الرموز الدينية، ولكنها يمكن أن تتسرب إلى نسيج أيديولوجياتنا ذاته، وغالبًا ما تتنكر في شكل علمانية.
إن العلمانية، في جوهرها، ليست مجرد غياب التأثير الديني في الشؤون العامة، بل هي التزام بالتعددية والتسامح والفصل بين السلطات الدينية وسلطات الدولة. ومع ذلك، عندما تصبح العلمانية عقائدية، وتصر على رؤية متجانسة لما يشكل الطريقة “الصحيحة” للعيش أو الحكم، فإنها تعكس جمود وعدم تسامح الأصوليات التي تسعى إلى معارضتها.
وبالتالي فإن التحدي لا يكمن في مكافحة الأصولية الدينية العلنية فحسب، بل في مواجهة الأشكال الأكثر دقة من الأصولية التي يمكن أن تتسلل إلى الإيديولوجيات العلمانية، وتجعلها إقصائية وغير متسامحة مثل العقائد الدينية التي تنتقدها. وهذا يتطلب يقظة مستمرة ضد أي أيديولوجية تسعى إلى فرض حقيقة واحدة أو أسلوب حياة فريد على الشعب.
والسؤال: هل نحن علمانيون أم أننا أصوليون في ثوب علماني؟ بمثابة مرآة نقدية تعكس أيديولوجياتنا المجتمعية والشخصية. وهو يحثنا على فحص ما إذا كانت علمانيتنا تحتضن التنوع وتعزز الحوار أو ما إذا كانت قد أصبحت شكلاً آخر من أشكال العقيدة، رافضةً أي انحراف عن معاييرها باعتبارها متخلفة أو غير شرعية.
وفي الإبحار في هذه التضاريس المعقدة، يتعين علينا أن نسعى جاهدين من أجل علمانية منفتحة، شاملة، وقابلة للتكيف، مع إدراك أن قوة المجتمع لا تكمن في توحيده بل في قدرته على استيعاب العديد من الأصوات ووجهات النظر. هذه هي العلمانية التي يمكنها أن تساهم بشكل حقيقي في القضاء على الأصولية بكافة أشكالها، من خلال تعزيز ثقافة التساؤل والتعلم والاحترام المتبادل.
العلمانية، في بساطتها، لا تفرض القبول ولا تملي الرفض؛ فهي تجسد بشكل أساسي التأمل والانفتاح على الحوار. ليس مطلوبًا منك اعتناق المتدين لتكون علمانيًا، ولا يجب عليك قبول الملحدين حتى تصبح علمانيًا. ومع ذلك، لا يمكنك بالضرورة استبعاد أي من المجموعتين، ولا يمكنك رفض الدخول في حوار مع أي منهما. والأهم من ذلك، أنك لا ترفض التعايش مع أحد، طالما أن جميع الأطراف تعترف بضرورة التعايش داخل دولة علمانية.
أيها السيدات والسادة، إن العلمانية تحافظ على مسافة متساوية من الجميع. وهي لا تبالي بفلسفتك الشخصية طالما أنك تقف بجانبها دون أن تفرض عواقبها على الآخرين. وتمتد هذه الشمولية حتى إلى العلمانيين أنفسهم. ولكن هل ستواجه بعض النظريات وأتباعها تحديات داخل هذا النظام من خلال التدقيق في أطروحاتهم وأقوالهم؟ مما لا شك فيه. فالعلمانية ليست ليبرالية مطلقة تسمح بالتعبير غير المقيد… العلمانية ستكون بمثابة رجل القانون على الجميع، وأي أطروحة إقصائية لن تجد مكانا في عالم علماني.
يسلط هذا المبدأ الضوء على العلمانية كإطار منضبط يسعى إلى تحقيق التوازن بين وجهات النظر التي لا تعد ولا تحصى داخل المجتمع، مما يضمن عدم سيطرة أي وجهة نظر على حساب الآخرين. إنها دعوة للاحترام الانساني المتبادل، ولكن هذا الاحترام لايعني بالضرورة الاعتراف بمعتقدات وأفكار الآخرين. وفي نفس الوقت تراها لاتمانع بل وترحب بطرح أي فكرة، كفرصة لإثراء النسيج المجتمعي.
وهذا لا يعني موقفا سلبيا أو غير مبال؛ بل إن العلمانية تتعامل بنشاط مع وجهات نظر مختلفة لتعزيز بيئة يزدهر فيها الحوار والنقاش. وهو يتطلب اتباع نهج يقظ للحماية من زحف الأيديولوجيات التي تسعى إلى تقويض الأساس التعددي للمجتمع العلماني.
في جوهر الأمر، تُعَد الدولة العلمانية حكمًا محايدًا، يضمن بقاء الفضاء العام مفتوحًا للجميع، وخاليًا من هيمنة أي أيديولوجية بعينها. إنه التزام بالمبدأ القائل بأنه على الرغم من أن الأفراد أحرار في اعتناق معتقداتهم وممارستها، إلا أنه لا ينبغي أن تنتهك حقوق الآخرين أو تعطل النظام الجماعي.
تعترف التحديات المذكورة بأنه لا توجد أيديولوجية، بما في ذلك العلمانية نفسها، محصنة ضد التدقيق داخل إطار علماني. إنه اعتراف بأن الرحلة نحو مجتمع علماني حقيقي مستمرة، وتتطلب يقظة مستمرة لمنع ظهور الاطروحات الإقصائية.
في هذه الرؤية للعلمانية، يتم التركيز على التعايش والحوار، وليس مجرد التسامح. إنها عملية مشاركة نشطة تسعى إلى الفهم والتكيف، بدلاً من الفصل أو القمع. يتعلق الأمر بخلق مجتمع لا يتم فيه التسامح مع الاختلافات فحسب، بل يتم تقديرها كمكونات أساسية لمجتمع ديناميكي نابض بالحياة.
إن الأصولية، بكل أشكالها، سواء كانت دينية أو علمانية، اسلامية، يهودية، أم مسيحية، شيعية أم سنية، كاثوليكية بروتستانتية، أو ارثذوكسية، مهما كان مظهرها، ستواجه حتماً المحاكمة أمام الإنسانية عاجلاً أم آجلاً. فهي لا تمثل أكثر من انفصال عن الحضارة، وقناعة مبنية على تفاهمات أو إنجازات تسبق تصوراتنا الحالية.
ليس بالضرورة أن يؤمن الأصولي بالأساطير المحيطة بما بعد الموت.. الأصولي هو كل من يعتقد أن أطروحته هي الحقيقة المطلقة، ولا مجال للنقاش أو الحوار. ولذلك نصيحتي للجميع وهذا يشملني أنا أيضاً أن نقف أمام المرآة ونقيّم أطروحاتنا بشكل نقدي قبل فوات الأوان. إلى حد ما، كلنا أصوليون… لقد حان الوقت لكي ندقق في ملامحنا… لنرى ماذا فعلت تجاعيد الأصولية بوجوهنا وعقولنا. وتلك المرآة لا يمكن أن تكون أكثر من عقل حر يصدمك ويدفعك إلى الأمام في نفس الوقت، وينصحك ويشجعك في آنٍ واحد.
يدعو هذا المنظور إلى إجراء فحص عميق واستبطاني لمعتقداتنا وقناعاتنا، مما يشكل تحديًا لنا لمواجهة الجمود الذي ربما تسلل إلى تفكيرنا. إنها دعوة للاعتراف بأن اليقين الذي نتمسك به بآرائنا قد لا يكون أكثر من انعكاس لعقلية أصولية اعتنقناها عن غير قصد.
تتضمن الرحلة نحو التغلب على الأصولية الاعتراف بالطبيعة الدقيقة والمعقدة للحقيقة وقيمة الحوار المفتوح والبناء. يتعلق الأمر بزراعة عقلية ترحب بالمعارضة، وترى المزايا في وجهات نظر بديلة، وتقدر النسيج الغني للفكر والخبرة البشرية.
تُعد استعارة المرآة بمثابة تذكير قوي بالاستبطان المطلوب للتنقل بشكل نقدي مع معتقداتنا وأيديولوجياتنا. فهو يشير إلى أن العقل الحر ــ العقل المنفتح والمتشكك والمقاوم للعقيدة ــ هو أفضل دفاع لنا ضد زحف التفكير الأصولي. مثل هذا العقل يعمل كحارس ومرشد، مما يساعدنا على تمييز الفرق بين الإدانة والعقيدة، بين العاطفة والتعصب.
في نهاية المطاف، لا يقتصر النضال ضد الأصولية على معارك خارجية مع أعداء إيديولوجيين فحسب؛ بل يتعلق الأمر بالنضال الداخلي للتأكد من أن قناعاتنا لا تتحول إلى عقيدة لا تتزعزع. إنها دعوة لتعزيز ثقافة التفكير النقدي، حيث يتم فحص الأفكار وإعادة فحصها، وحيث يتم الاحتفاظ بالمعتقدات بتواضع، وحيث يتم الاحتفاء بقدرة الإنسان على النمو والتعلم.
ومن خلال تبني هذا النهج، فإننا لا ندافع عن مخاطر الأصولية فحسب، بل نثري أيضًا فهمنا وتقديرنا للعالم المتنوع الذي نعيش فيه. نحن نفسح المجال لخطاب أكثر شمولاً وتعاطفًا واستنارة يعترف بالقيمة المتأصلة لكل صوت في الفكر الإنساني.